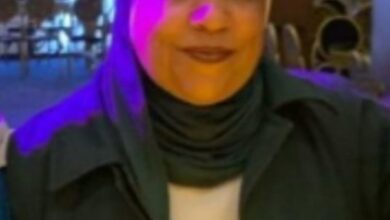“لقاء مع بورخيس”

✍️ القاص سعيد رضواني :
لا أحد غيري رآه قادما نحوي، ولا أحد غيره رآني واقفا أنتظر وصوله، أما أعين أصدقائنا من قناصي الكلمات، التي ستصوب أبصارها نحونا لاحقا، فستعرف أنني التقيت مبدع المتاهات القصصية في الطريق إلى البحر، مثلما سأعرف أنا أن حشد محبي الكتب وعشاق الكلمات، الذين كانوا متوجهين إلى معرض الكتاب المحاذي للمحيط الأطلسي، قد جذبهم مثلي مهاد الرمل والسائل الحريري الممتد على طول المحيط، فقصدوا البحر كي ينعشوا أنفسهم برذاذه المتطاير فوق الرصيف الشاطئي.
قبل أن تصافح يدي الباردة المنسلة من تحت الكتب يده الدافئة الخارجة من جيب معطفه، أدركت أن لقاءنا سيدفئه، كما العادة، حديث مترع بالعلم والمعرفة والأدب يدور بيننا، قبل أن ينعطف في اتجاه المعرض، أو ربما سيقصد الشاطئ ليتحرر مثلي من ضغط غابة الإسمنت، ومن زعيق الحراشف المعدنية المكتظة فوق ظهور الثعابين الاسفلتية التي تخترق الدروب الصاخبة والأحياء الضاجة بالحركة.
في مفترق الطرق أو ملتقاها حيث أقف، التقينا قرب بائع جرائد يفترش زاوية رصيف مواجه للمدار. ولم أكن أدري أن فيه، بعد لحظات، سيحل الفراق، مثلما لم أكن أعلم قبل أن يخبرني، دون مبالغة في التأسف، أن بصره بدأ يضعف وينذر بالعمى، لكنني كنت متأكدا أن جملته: “لعل كتب الأدب هي آخر ما ينفعنا في كتابة الأدب”، التي قالها بالعربية بعدما حياني بالإسبانية وانحنى قليلا ليدقق في العناوين المطبوعة في منتصف غلاف كل كتاب من الكتب التي أحملها، ستغير قناعتي من نقيض إلى نقيض.
لا أحد سمعه يفحمني بجملته الدامغة، ولا أحد سمعني أعترض عليه بما يشبه الهذيان. ورغم ذلك، شعرت بأن الكون كله، بشموسه وأقماره ونجومه وسدمه، قد أصاخ السمع إلى جملته الغريبة التي انهارت أمام تماسكها هشاشة اعتراضي.
رمى بجملته تلك غير مبال بوقع حدة غرابتها على قلب متيم بالأدب، ثم أردفها بجملة أخرى أكثر حدة وغرابة مصحوبة بإشارة من أصبعه إلى موطئ أقدامنا:
“في مكان كهذا، وقد كنت في مثل سنك تقريبا أحمل أيضا بعض الروايات، التقيت برجل في مثل السن الذي أنا عليه الآن، أدهشني بمثل ما قلته لك”.
لم أقو على التوازن بين مرايا وهمية متقابلة تعكس عالمين متناظرين حقيقيين، فرفعت رأسي إلى سماء واقعي لعلها تحميني من دوار سماء عالمه، ورنوت إلى قمر النهار، قمر الشعراء، ذاك القرص الشفاف الشاحب الذي أهانه العلم بأسفل حذاء أرمسترونغ، ثم غصت ببصري في عمق السماء أتأمل كلامه الغريب.
وكما لو أن صفاء زرقة السماء أعْدى ذهني التواق إلى الانتعاش. أنعشتُه بملوحة ذرات سحبتها مع هواء ندي، ثم نظرت إلى بورخيس وعقبت: “فعلا. أعتقد أن الأديبان تشيكوف ويوسف إدريس استفادا من الطب في كتابة الأدب”.
صمت قليلا، ثم أضاف وهو يمسح زجاج نظارات سلها من جيبه: “ولعل كتب العلم أيضا هي آخر ما ينفعنا في العلم. ومؤكد أن فرويد الذي كان مولعا بروايات دوستويفسكي استفاد من الأدب في الطب”.
شعرت برضى وأنا أسمعه يعلن أن العلم والأدب متكاملان، ودون محاولة إخفاء ابتسامة تشي بانحيازي السافر للأدب رغم ولعي بالعلم قلت: “دوستويفسكي وسوفكليس أيضا، ومنه اقتبس عقدتا أوديب وإليكترا”.
لم يرتد النظارات بل أعادها إلى جيبه، وشرد دون أن يبدي اهتماما بهذا المسرحي الذي أقحمت اسمه في الحديث بعدما اقتلعته من أمام مقاعد المسارح اليونانية الحجرية. أو ربما بدا لي الأمر كذلك. أو لعله انشغل عن سوفكليس بشيء آخر؛ بمسرحية أخرى على خشبة واطئة في طابق عميق من طبقات نفسه.
خشية أن يطول هذا الفصل المسرحي، قررت إسدال الستار عليه، وإعادة بطله إلى مسرحٍ خشبته رصيفٌ يُطل على ملتقى الطرقات. وحتى يكون الانتقال سلسا بين الخشبتين، جاهدت كي أجعل صوتي مسرحيا وأنا أخبره بإطراء أحد محبيه.
انتبه إلى ما قلته وأطرق رأسه، ثم عقب بهدوء: “أَشكره لأنه تذكرني”.
فاجأني رده الفاتر، فتجاسرت وأنبأته بتقريع أحد منتقديه. ومرة أخرى، لم يبد أي انفعال، بل تجاوب مع النبأ بمثل تجاوبه مع الذي سلف قائلا: “أَشكره لأنه تذكرني”.
أدهشني تصالحه مع المتناقضات، وهو أمر لطالما تمنيت تحقيقه. أفصحت له بما فكرت فيه وقلت: ” في هذه اللحظة التي يتحقق فيها عينيا، في شخص آخر، ما أطمح أن أكونه أنا، أتمنى حقا لو كنت أنا هو أنت”.
لم يتفاجأ بما قلت، بل صمت طويلا مداعبا نظاراته التي اعتادت التنقل بين الجيب واليدين، دون أن تحظى، ولو مرة واحدة، بشرف دعم بصر عينيه، ثم عقب:
“ألا تخشى من المقارنات؟ ألا تخشى، وأنت تريد أن تكونني، في حالة ما لم نتطابق تماما، من أن تصبح فقط جزءا مني، وتغدو أفكاري مرآة لأفكارك، وخيالك مجرد انعكاس لخيالي؟”.
أدركت أن سؤاله خطير وعميق، وأي فشل في الإجابة يعني الفشل في أن أكونه أو أكون نفسي، فأطرقت أفكر طويلا، ثم أجبت بثقة:
“إذا أصبحت أنا أنت، فسأكون مكانك الآن إزاء شخص آخر، وقد يكون هذا الشخص هو أنت. وفي النهاية لن يتغير أي شيء سوى قلب الأدوار. وإذا لم أصبح أنا هو أنت، فلن أخشى من أي مقارنة، فلكل منا عالمه المستقل، مثلما لمْ تخش أنت اتهاما مماثلا عندما قلتَ ذات مرة: “لقد حاولت جاهدا أن أكون كافكا، غير أنني لم أفلح في ذلك الأمر. أن أكون بورخيس هذا يعني أن أكون إلى حد ما كافكا”.
صمتّ قليلا ثم تابعت:
“أعتقد أن اطمئنانك راجع إلى إدراكك العميق طبيعة البرزخ الذي يفصل عالمك عن عالم كافكا. متاهة كافكا وجودية، بينما متاهتك ذهنية. يعكس كافكا متاهته في كوابيس الشبكة البيروقراطية، بينما تعكسها أنت في تقاطعات الأمكنة وتداخلات الأزمنة.
أنا أيضا حاولت الاشتغال على المرايا والمتاهات، لكنني قطعا لم أشتغل على المرآة والمتاهات بالشكل الذي اشتغلت أنت به عليهما. لقد جعلتَ من قبو قصتك “الأَلِفِ” مرآة تمكنك في لحظة واحدة من رصد جميع الأمكنة في جميع الأزمنة، ومع ذلك لم تخش أن يُعتبر أَلِفُك/مرآتك انعكاسا لمرآة الكاهن يوحنا التي تعكس العالم كله”.
التفتّ جهة البحر لأستنشق مزيدا من الهواء الندي، ثم أضفت: “اشتغلت أنت على المرايا كأدوات وتيمات، بينما حاولت أنا أن أجعل السرد نفسه مرآويا ينعكس بعضه على بعض، مركزا على المتاهة في السرد. وأتمنى أن أكون قد أفلحت في هذا، مثلما أتمنى أن أكون قد نجحت في تجنب متاهاتك ومتاهات كافكا. وعدا ما طرحتُه الآن من تماثلات، فقد أردت فقط التعبير عن حبي لك، لكنني لا أريد أن أكون إلا أنا”.
بعدما أتممت كلامي، شعرت كما لو راعه ما قلت، فقد جحظت عيناه حتى خشيتُ على ما تبقى من قدرات بصره. تتبعت نظراته فرأيته يشيع قطا مخططا متجها إلى مركز المدار. خمنتُ أنه ربما يرى فيه سلالة متعددة من نمور سيبيرية موشحة بشبكة متداخلة متقاطعة من الخطوط. أما أنا، فرأيت فيه سلالة مضغوطة من القطط، وخريطة من البقع ومن الخطوط المتماثلة على امتداد مسافات شاسعة من الفراء، فأوحى لي تفكيري هذا بخطوط أخرى متقابلة تكونها مسارات حيواتنا المتناظرة. ولأخفف من حدة تصوري، أضفت تحت تأثير ما أوحت لي به خطوط هذا القط:
“إن سعينا المستميت نحو تحقيق خصوصية تامة غالبا ما يصطدم بعدة عقبات، فقدَرُنا أن نحاط دائما بأناس مشابهين لنا وأحداث تماثل وقائعنا. أشياء كثيرة تتكرر حولنا لا تميزها إلا اختلافات طفيفة. وُقُوفنا هنا له نظائر متعددة في أمكنة مختلفة، وكأننا مرايا تنعكس على بعضها بعض”.
صمتّ قليلا أحدق في عينيه المشدوهتين، ثم أضفت: “البارحة فكرت في كتابة قصة حكايتها مترابطة، وأحداثها متماسكة ككل الأحداث المتسلسلة التي تعيشها أغلب العائلات، لكنني فكرت في جعل حلقات الأحداث المتسلسلة موزعة على عشرات العائلات. هكذا أرى العالم؛ حكاية واحدة نُسخها متعددة، تكاد تتشابه وتتطابق”.
خيم علينا صمت استمر بضع لحظات، قبل أن تكسره جلبة حشود تتجه صوب البحر. نظر باستياء تجاه مصدر الجلبة، ثم التقط نفسا عميقا، وقال بنبرة قوية:
“كتبت كثيرا عن المصائر المتداخلة والمتقاطعة والمتشابكة وحتى المتناقضة، لكن لم تخطر على بالي قط الكتابة عن الحيوات المتوازية والمتناظرة. والآن، وأنا أتأمل أفكارك عن التناظر، وأرى فيك ذاك الطموح المتوهج الذي كان لدي مثله فيما مضى، أتمنى حقا لو كنت أنا هو أنت”.
صعقني رده، وربما لاحظ أثر الصعقة في ملامحي، ومع ذلك لم يكتف بهذا، بل أعقبه بقوله:
“ربما جميعنا، وإن بدونا منفصلين، نكوّن كيانا واحدا لا يتجزأ؛ وهذه هي طبيعة الإنسان. كن أنت ولا شيء آخر. فمهما اتفقنا أو اختلفنا، فأفكارك وأفكاري، روحك وروحي، ربما تشكل كيانا واحدا غير مرئي مختلف عني وعنك”.
تأملت ما قاله توا، وبعد ذلك فكرت في جملته السابقة “أَشكره لأنه تذكرني”، التي شكلت تعليقا واحدا على حالتين ليستا مختلفتين فحسب، بل ومتناقضتين أيضا: الإطراء والتقريع. ثم همست لنفسي: “بورخيس محبُّ الإيجاز، وسيدُ الردود”.
لقد دافعتُ مرارا بحجج مختلفة عن العلاقة التكاملية بين الأدب والعلم، وخلال كل محطات الدفاع، لم أجد صيغة تمثل هذا التكامل أفضل من “اليانغ يونغ”، بيد أنني اليوم وجدت في ردوده وتعليقاته رموزا أخرى تمثل هذا التكامل.
خمنت أن الشمس تواطأت مع القمر والرمل والبحر والرذاذ المالح، واستدعتنا لتنفيذ مخطط مخاتل.
نظرت إليه، فوجدته قد شرد مرة أخرى. قدّرت أنه ربما يحاور نفسه في أمور بعيدة عن العلم والأدب، وفكرت على نحو يجعل تفكيري كما لو يتدحرج على الأثر الذي يخلفه تفكيره: “إن التباعد أيضا قد يكون نوعا من التقارب”.
ارتأيت ترك رواياتي عند بائع الجرائد إلى حين عودتي من جولة على الشاطئ. في اللحظة التي أردت تسليمها إلى البائع، رأيت عيني بورخيس تشرقان من جديد، وتحدقان في وجهي قبل أن يشيح ببصره عني، ويركز على الروايات. استأذنني في تصفحها وهو يخرج يديه من جيبي معطفه. ناولته الكتب، وأدخلت يديّ في جيبي معطفي متوقعا أن يمدني بمعلومات مستجدة عن مضامين آخر قراءاته الأدبية أو العلمية تدفئ شغفي للمعرفة، فإذا به يستفيض في الحديث عن الأغلفة ونوعية الورق وأنواع الخطوط التي طُبعت بها هذه الروايات. لم أصب بخيبة ظن، بل فكرت: “ربما الشكل جزء من المضمون، أو المضمون جزء من الشكل، أو ربما هما معا كيان واحد لا يتجزأ”.
أخبرني أنه سيذهب إلى المعرض، فقررت تركه في الملتقى الطرقي قرب بائع الجرائد. صافحتْ يدي الدافئة التي أخرجتها من جيب معطفي، يده الباردة التي سلها من تحت الكتب، وقصدت قدماي حاجزا حجريا يطل على البحر، لعل ضغط أفكاري يتبدد مع ذرات الماء المتطايرة مع الهواء.
تأملت سفينة تنحدر ثم تختفي وراء الأفق، ففكرت في السفر ليس في المكان بل في الزمن، ذاك السفر الذي يمثل ذروة طموح العلماء. دون سابق قرار، وجدتني أفكر في بعض الروايات الرديئة التي أهانت في بواطنها العلم، وهي تهين تيمة السفر في الزمن. أشحت بوجهي عن البحر خجلا من هذا الخاطر المسيئ للأدب، وتطلعت جهة الممر المؤدي إلى مدخل المعرض كي أرى بورخيس فلم أعثر له على أثر. أسندت ساعدي إلى أعلى الحاجز أتأمل الأمواج والطيور والسفن والأفق، وبعد لحظات بدلت التأمل بالتفكير:
“لعل كتب الأدب فعلا هي آخر ما ينفعنا في كتابة الأدب، فعلم التعقيد يعلمنا أن تكسير أفق الانتظار في الأعمال الأدبية هو محاكاة فنية لسلسلة تفاعلات فيزيائية، تنبثق عنها خواص غير منتظرة منطقيا، وأن التلاعب بالزمن، والسفر فيه سردا، هو توظيف ذكي للإرث الذي خلفته لنا الفيزياء النظرية، والذي يجعل من اللحظات الزمنية أحداثا يختلف زمن وقوعها حسب المسافة الفاصلة بين راصد وآخر. أحسست بنشوة جراء هذا الاستنتاج، فأخذت نفسا عميقا، ثم عدت للتفكير:
“ربما ما يجمعنا هو ما يفرقنا. وما يشتتنا هو ما يوحدنا. وما يقرب بعضنا لبعض هو الذي يباعد بيننا. وملتقى الطرق، حيث التقيت بورخيس، هو نفسه مفترقها”.
لا أحد ممن حولي علم شيئا عما حدثت به نفسي، ولا أحد منهم رأى نفسي تصيخ السمع إليّ، بيد أنني أعتقد أن ذلك الكائن الثالث الذي اقترحه بورخيس كان يقف شاهدا على تفاصيل هذا الحديث الذاتي.
شعرت بإشباع من التأمل والتفكير، فقررت إراحة ذهني باجتياز المسافة الفاصلة بين مكاني هذا والمعرض، بخطوات تنقل التعب من الذهن إلى القدمين. في الطريق، مررت ببائع الجرائد لأستعيد كتبي. سلمني إياها ومعها ورقة مطوية. فتحتها، فتعرفت في الحال على خط بورخيس، وشرعت أقرأ باهتمام:
“كما أخبرتك، كنت أنوي زيارة المعرض، لكنني قررت تأجيل الزيارة إلى ما بعد التوجه إلى البحر كي أتنسم الهواء وبعض العزلة. والآن، بعدما عج الطريق الشاطئي بالبشر اضطررت للعدول عن الفكرة، والذهاب مباشرة إلى المعرض.
فكرتُ بطريقة صحيحة في أن الجميع سينشغل بالتجول في المعرض وسأختلي بنفسي دون ضجيج في البحر، لكنني خلصت إلى نتيجة خاطئة. ربما لأن الآخرين أيضا فكروا مثلي. في المرة القادمة، سأفكر بطريقة خاطئة لعلي أصل إلى نتيجة صحيحة.
آمل أن نلتقي في المعرض. سأكون عند الكتبي الأول إذا دخلت من الباب الثاني”.
طويت الورقة ودسستها بين دفتي رواية، ثم أكملت الطريق.
دخلت المعرض، وقصدت ذلك الكتبي الذي حدَّدَته الرسالة. شعرت أنني أمام رجل يبدو بزيه الغاوتشو كأنه قادم من مكان بعيد ومن زمن أبعد. حييته فرد التحية بلغة هجينة (بيدجين). أدركت فورا أنه أرجنتيني. سألته عن بورخيس، وأنا أتفحص غلاف طبعة قديمة من رواية “اختراع موريل” ل أدولفو بيوي كاساريس، فأكد لي أنه مر به، واقتنى كتبا تركها مع معطفه في مكتبته، إلى حين رغبته في مغادرة المعرض.
لم يسبق لنا التواصل هاتفيا، لذا طفت في مشارق المعرض ومغاربه لعلي أصادفه، وأنا مسلح باعتقاد راسخ أن رفوف الكتب الأدبية ستجمعني به. ورغم يقيني أنه كان وربما ما زال في المعرض، إلا أنني لم أعثر عليه.
لعل رفوف كتب الأدب التي راهنتُ عليها في أمر لقائه هي نفسها التي كانت تفصل بيننا، أو لعل بورخيس كان موجودا في أروقة تهتم كتبها بمجالات بعيدة عن الأدب.
لم يمنحني موعدُ لقاءٍ، برمجته سلفا مع أحد الأصدقاء، فرصة المكوث أكثر في المعرض، فقررت المغادرة. في طريقي إلى باب الخروج، مررت بالكتبي، فأكد لي أنه لم يعد بعد من جولته، ومن المؤكد سيعود ليأخذ معطفه والكتب.
نظرت إلى الساعة، فأدركت أن الوقت ينفذ، وقررت الانصراف وأنا أفكر في أن حماستي الزائدة قد تواطأت مع خيالي الجامح وولعي بالأدب وعشقي العلم، فاستدعت الشمس والقمر والرمل والبحر والرذاذ المالح والكتب وبورخيس، لتنفيذ مخطط مخاتل: كتابة قصة عن النظائر المتعددة.
وقبل ان أغادر المعرض، كتبت رسالة لبورخيس وتركتها عند الكتبي:
“لم يسبق لنا أن التقينا داخل أي معرض كتاب. كل لقاءاتنا تمت إما في المقاهي أو الحدائق أو شواطئ البحار. واليوم، أصررت على تحقيق هذا الأمر، لكن يبدو أنني أيضا فكرت بطريقة صحيحة ووصلت إلى نتيجة خاطئة. فكرت أن أروقة الكتب الأدبية ستجمعنا، وربما هي ما فرق بيننا. في المرة القادمة، أنا أيضا، سأفكر بطريقة خاطئة لعلي أصل إلى نتيجة صحيحة، فأعثر عليك.
يبدو أن مصائرنا تأبى أن تتقاطع داخل أي معرض كتب، إما لأننا كنا في المعرض نسير في طريقين متوازيين، وتحتم أن ينزاح أحدنا عن مساره كي يتحقق لنا اللقاء. وإما كان كل شيء توهما، وكنا نحن في زمنين مختلفين، ووجب على أحدنا أن يسافر في الزمن كي تلتقي مصائرنا ويتحقق ذلك الكائن الثالث الذي لا يشبهني ولا يشبهك رغم أنه يتشكل من روحي وروحك، ذلك الكائن الذي يجتمع فيه ماضيك المفترض مع مستقبلي المأمول.
أترك لك هذه الورقة وأنا أعرف، منذ الآن، قياسا على ما تُعقب به دائما على طروحاتي، أنك ستعلق بعد قراءتها جهرا أو سرا: “أرى أنك قلبت سهم الزمن. والصواب أن تقول: ذلك الكائن الذي يجتمع فيه ماضيك أنت المفترض مع مستقبلي المأمول، لأنني سبقتك إلى هذه الدنيا بفارق زمن طويل”.
أنا متأكد أنك ستفكر هكذا، لأنني أعرف أننا مهما اختلفنا على الأقل نتشابه في شيء واحد؛ هو إصرارنا على إراقة دم الغرور، وأنك مثلي تفضل أن تكون مجرد شبح في مرآة ماري الدموية المظلومة، على أن تكون ضحية المرآة المائية التي أغوت نارسيس”.