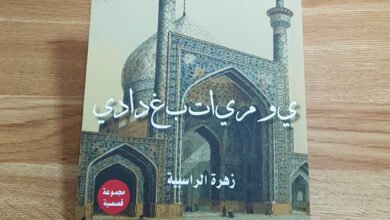صلاح الغافري.. حين تتحدث القصيدة بلسان الهندسة ويصبح الإيقاع وطنًا للروح… في ضيافة مجلس الحكواتي الثقافي
حاوره الأستاذ فايل المطاعني

في أمسيةٍ يعبق فيها الحرف بعطر الإبداع، ويجتمع الفكر بالعاطفة في مجلسٍ يحتفي بالكلمة، استضاف مجلس الحكواتي الثقافي الشاعر العُماني الفصيح صلاح بن سالم بن محمد الغافري؛ المهندس الذي شيّد من الشعر جسورًا بين الحسّ والعقل، ومن الإيقاع وطنًا للروح الباحثة عن الجمال.
الغافري صوتٌ شعريّ مفعمٌ بالصفاء والمعرفة، جمع بين الموهبة الفطرية والخلفية العلمية الدقيقة، فصاغ قصيدته بموازين منضبطة ووجدانٍ نابض.
في هذا الحوار الخاص، نرافقه في رحلةٍ تمتد من طفولته المولعة بالمعلقات إلى تجربته في الغربة، ومن المختبر إلى المنصة، حيث تتجلى رؤيته للشعر الرقمي، وتتكشف فلسفته في أن الشعر رسالة لا تموت، بل تتجدد مع كل نبضة إيقاع.
وإليكم تفاصيل هذا الحوار الذي أدارَه الأستاذ فايل المطاعني – الحكواتي:
س1: متى شعرت أن الشعر سيكون جزءًا أساسيًا من حياتك؟
ج1: سؤال جميل لبداية حوار شيق. قد لا تستوجب إجابته الإطالة، لكني سأستفيض قليلًا من باب متعة استحضار الذاكرة.
الشعر استوطنني شغفًا واطّلاعًا منذ باكورة الوعي، وأنا تلميذ صغير على مقاعد الدراسة الابتدائية، إذ وجدتني مأخوذًا بهذا الفن الجميل الذي يُسمى الشعر بكل صوره وقوالبه وبحوره وأغراضه. كنت أحفظ الأبيات المدرسية فطريًا دون جهد، وأستمتع بترديدها، ولم يكن الحفظ يشكّل عبئًا عليّ كما كان عند زملائي.
ومع بلوغي أواخر المرحلة الابتدائية وبداية الإعدادية، بدأ هذا الشغف يتجذر في صور شتى: بحثت بنهم عن درر الشعراء العرب، من المعلقات وشعر الجاهلية إلى شعر صدر الإسلام والعصرين الأموي والعباسي، وعلى رأسهم المتنبي، ثم الشعراء المحدثين وفي مقدمتهم أحمد شوقي.
أما شعراء عُمان الكبار، وعلى رأسهم أبو مسلم البهلاني، فقد تعرفت عليهم في المرحلة الثانوية والجامعية، ونهلت من معينهم الزاخر.
ورغم أن دراستي كانت علمية، إلا أن قراءاتي كشفت لي جمال علم العَروض وارتباطه بالسليقة العربية، ووجدت نفسي أكتب على أي بحر أشاء دون تعثر في الوزن أو القافية، بفضل تلك السليقة التي وهبها الله لي ولله الحمد.
س2: كيف أثر شغفك بالقراءة في تكوين رؤيتك الشعرية؟
ج2: كان التأثير كبيرًا جدًا. يمكن القول إن شغف القراءة هو الذي أوجد الرؤية الشعرية في الأساس، فقد لازمني حب القراءة منذ نعومة أظفاري، أما الموهبة الشعرية فقد تجلت لاحقًا في أواخر المرحلة المدرسية وقبيل الجامعة.
أكاد أجزم أن الوجدان قد تشبع أولًا بالمخزون الشعري، ثم فاض فأثمر موهبة، كالشجرة التي نمت في تربة خصبة، فلما ارتوت واشتد عودها أثمرت وأينعت.
س3: ما الذي جذبك تحديدًا إلى المعلقات وكتب التراث العربي؟
ج3: كل شيء فيها جاذب؛ قوة الكلمة، جزالة المفردة، عمق الفكرة، فخامة الصورة، والبلاغة الآسرة.
اللغة العربية بحق أجمل اللغات، فكيف بشعرها الأصيل في المعلقات وتراث العرب الأقحاح ذوي اللسان المبين؟
أما من حيث المضمون، ففي ذلك التراث العجب العجاب؛ إذ كان أكثر شعراء المعلقات من الأميين الذين قاسوا شظف العيش وضنكه، ومع ذلك أبدعوا شعرًا يجمع بين سلاسة اللفظ وعمق التصوير دون تكلف.
ولذلك ظل تراث العرب الشعري ملهمًا لي، أعود إليه كلما أردت أن أروّي ذائقتي وأشحذ لغتي.
س4: لديك خلفية علمية قوية في الهندسة وهندسة البترول، كيف أثر ذلك على شعرك؟
ج4: الخلفية العلمية والهندسية أثّرت بعمق في تجربتي الشعرية ونضجها. فالموهبة يرسخها العلم وتصقلها التجربة.
الشعر كأي موهبة أخرى يحتاج إلى انضباط وتنظيم ليثمر عطاءً. الانضباط ليس فقط في اختيار المواضيع، بل حتى في ترتيب الأفكار وصياغتها داخل النص، وفي ترابط الصور والمفردات.
وفي تجربتي الخاصة، كثير من هذا الانضباط اكتسبته من خلفيتي العلمية والهندسية.
س5: هل وجدت أن التوازن بين العلم والفن ساعدك في صياغة لغة دقيقة ومنسقة؟
ج5: بالتأكيد. هذا التوازن خلق حالة من التناغم بين الجانبين. فكما أن روح الشعر ولّدت فيّ بيئة عملية خلاقة، فإن الجانب العلمي المنظم ساعدني في صياغة لغة شعرية دقيقة ومنسقة. وهكذا تشكّل داخلي توازن جميل بين صرامة العقل ورهافة الحس.
س6: كيف أثر العيش في المملكة المتحدة وتجربتك الأكاديمية هناك على أسلوبك الشعري؟
ج6: الغربة أينما كانت مدرسة كبرى، إن أُحسن التعاطي معها. فهي تنقّي الروح، وتوقظ الوجدان، وتفجّر الطاقات الكامنة في النفس. فيها تجرّد من المحيط، واشتياق، وبناء للذات واستقلالية.
كل ذلك يصقل الموهبة ويرتقي بها.
أما تجربتي في المملكة المتحدة، فقد كانت ثرية بحق؛ أثّرت في لغتي الشعرية وصقلت أدواتي الفكرية والحضارية، وأكسبتني بعدًا إنسانيًا أعمق، حتى أصبحت الغربة مدرسة أخرى لقلمي وقلبي معًا.
س7: لاحظنا اهتمامك الكبير بالإلقاء الصوتي، ما سر هذه العلاقة بين الصوت والكلمة عندك؟
ج7: أولي الإلقاء الصوتي اهتمامًا كبيرًا، وأعدّه ركيزة أساسية لإيصال النص إلى الجمهور. فالمنشدون الذين يقدّمون أعمالي هم سفراء بوحي وإحساسي، والحناجر العذبة التي تبث الحياة في كلماتي.
أما عن إلقائي الذاتي، فأميل لتجنبه لعلمي بضعفي في هذا الجانب، كما قيل: “رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه”. ومع ذلك، هناك نصوص أشعر أنها تجسدني قلبًا وروحًا، فألقيها بنفسي حين أوقن أن صوتي هو امتداد لقلبي.
س8: كيف تختار القصيدة أو النص الذي ستقدمه على المنصات الرقمية؟
ج8: أختار النص عادةً وفق المناسبة الزمنية أو القضية الراهنة. أفضّل الأعمال ذات الرسائل المجتمعية أو القومية أو الإسلامية العامة، لأنها تلامس قلوب الناس وتُبقي أثرًا أطول.
أما النصوص الشخصية فتأتي في المرتبة الأخيرة من حيث النشر. فأنا أؤمن أن ما يهمّ المتلقي هو ما يلامس وجدانه وقضاياه.
وما أراه أن الشعر رسالة، ومتى صدقت الرسالة صدح بها الناس.
س9: هل لديك لحظات لا تُنسى من الأمسيات الشعرية التي قدمتها في الخارج؟
ج9: نعم، لي مواقف طريفة وأخرى ملهمة.
في إحدى الجامعات البريطانية عام 2003، ألقيت قصيدة تندد بالاجتياح الأمريكي للعراق، فلاحظت الإرتباك على وجه المنظم إذ لم يكن يعلم بموضوعها مسبقًا. وبعد الأمسية قال لي بقلق: “أرجو ألا يضعنا نصك هذا تحت طائلة المساءلة فنحن نقطن في بلد يدعم هذا الاجتياح سياسياً وعسكرياً!”، فطمأنته مبتسمًا بأن المسؤولية تقع على رأسي وحدي.
وفي أمسية أخرى، اقترب مني رجل ستينيّ، بدا عليه الأدب والعلم، فأثنى على قصيدتي وأهداني نصائح ثمينة في بداياتي، بقيت نبراسًا لي في مسيرتي الشعرية حتى اليوم.
س10: لديك أكثر من 70 عملًا منشورًا على يوتيوب وإنستغرام، كيف تختار المواضيع؟
ج10: تنوع المواضيع نابع من تنوع اهتماماتي؛ فمنها ما هو اجتماعي ووطني، ومنها ما هو ديني وتربوي وعاطفي وإنساني.
لكن في كثير من الأحيان أشعر أن الموضوع هو من يختارني لا العكس؛ يفرض نفسه على وجداني حتى يتجسد شعرًا.
فالشاعر، في رأيي، لا يختار موضوعه بقدر ما تختاره القصيدة لتولد على لسانه.
س11: من بين أعمالك، أيها الأقرب إلى قلبك ولماذا؟
ج11: سؤال صعب، فلكل عمل بصمته وروحه.
لكن من حيث السموّ الروحي أجد أن قصيدة “المعجزات النبوية” على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم هي الأقرب إلى قلبي.
هي بائية من ثلاثين بيتًا تناولت فيها اثنتي عشرة معجزة للنبي الكريم كما وردت في السيرة، وقد نشرتها بصوتين مختلفين: أحدهما بأداء المبدع عبدالهادي العبري، والآخر بتقنية الذكاء الاصطناعي. وأعتز بها أيّما اعتزاز.
س12: هل تفكر في دمج الشعر بالمنصات الصوتية الأخرى أو مشاريع إنشادية جماعية؟
ج12: نعم، أعمل حاليًا عبر مسارين:
الأول هو الإنتاج الصوتي التقليدي في الاستوديوهات بالتعاون مع منشدين وملحنين مختارين بعناية،
والثاني هو الإنتاج باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أزوّد البرنامج بالنص والعينة اللحنية المطلوبة للحصول على أداء أولي أقوم بمعالجته فنيًا وأدبيًا حتى يخرج متكاملًا.
أما النشر، فأساسيًا عبر “يوتيوب” و”إنستغرام”، وأحيانًا “تيك توك”. وإن أُتيح التوسع في منصات أخرى مستقبلاً فذلك محمود.
أما الإنشاد الجماعي، فهو مشروع أضعه في الحسبان لما يحمله من طابع جمالي وجماهيري.
س13: لقد تعاونت مع عدد من المنشدين العمانيين والمواهب الناشئة، كيف تختار شريكك في العمل الإنشادي؟
ج13: اختيار المنشد يعتمد على طبيعة النص وهدفه.
فإن كان حماسيًا اخترنا صوتًا قويًا جزلاً، وإن كان وجدانيًا فصوتًا عذبًا منسابًا، وإن كان تعليميًا فغالبًا نلجأ إلى مواهب ناشئة لشدّ انتباه الفئة الصغيرة.
وأحيانًا نمزج الأصوات لتحقيق التناغم والتنوع.
أما في التلحين فنعمل بروح الفريق مع المنشدين والملحنين ومهندس الإيقاع في جلسات عصف ذهني حتى نصل إلى لحن يُجمع عليه الجميع.
وخلاصة القول: القرار لدينا تشاوري لا فردي، لأن العمل الجماعي يثري التجربة ويزيدها نضجًا وإبداعًا.
س14: ما نصيحتك للشباب الذين يودون دخول عالم الشعر أو الإلقاء؟
ج14: الشعر والإلقاء موهبتان منفصلتان في الأصل والمنبع والصقل. فالشعر خلقٌ وجدانيّ، والإلقاء تجسيدٌ صوتيّ وحضوريّ.
من وُلدت فيه روح الشعر فعليه أن ينميها بالقراءة والإطلاع، ومن امتلك خامة صوتية فعليه أن يصقلها بالتدرب والتمرين.
أما من لم يجد جذوة الموهبة في داخله فالأمر عسير، إذ لا يُخلق الإبداع من العدم.
ومتى وُجدت الموهبة وجب أن تُسقى بالجد والمثابرة، فالموهبة بذرة، والسعي ماؤها، ومن جدّ وجد.
س15: رغم عدم صدور ديوان مطبوع حتى الآن، متى نتوقع رؤية ديوانك الورقي؟
ج15: المسألة ليست متعلقة بالتوقيت بقدر ما هي بالإقتناع. فمتى اقتنعت تمامًا بجدوى الإصدار الورقي ومساهمته في انتشاري، سيكون الموعد بإذن الله.
لدي بحمد الله مخزون وافر من النصوص يكفي لإصدار أكثر من ديوان، وما أنشره في “يوتيوب” و”إنستغرام” شاهد على ذلك.
ولكثرة ما ألقاه من تشجيع، أجد خطواتي تتسارع نحو التدوين الورقي، ولعل الديوان يرى النور قريبًا بإذن الله، ولو كان بدافع التوثيق أكثر من الانتشار.
س16: ما رؤيتك لمستقبل الشعر الرقمي في العالم العربي؟
ج16: سؤال عميق في الصميم.
في البداية كنت أظن أن عزوف الناس عن القراءة هو المشكلة، لكن مع الوقت أدركت أن الخلل ربما في الوسيلة، لا في المتلقي.
فالمنصات الرقمية غيّرت المشهد، وجعلت النص الأدبي أقرب إلى القارئ وأكثر تأثيرًا.
وأرى أن الشعر العربي وجد آفاقه الرحبة عبر هذه المنصات، ولا سيّما حين يُجسَّد إلقاءً أو إنشادًا، فيبلغ أثره مديات أبعد.
تجربتي الشخصية في الإنتاج الصوتي أكدت لي أن المستقبل للشعر الرقمي، وأن المشهد الأدبي العربي مقبل على نهضة رقمية مبهجة.
س17: إذا أردت أن يذكر الناس شعرك بكلمة واحدة، ماذا تريد أن تكون؟
ج17: إن كان التذكّر هدفًا، فالتأثير هو الغاية الأسمى.
فالشاعر يطمح أن يغيّر واقعًا يرى فيه بعض المثالب، وأن يترك بصمته الفكرية والوجدانية للأجيال.
فإن لم يكن الخلود بالأعمار، فليكن بالأثر.
إذاً فالكلمة التي أود أن يذكر بها الناس شعري هي: “الأثر”.
نشكر الشاعر صلاح الغافري على مشاركته هذه الجولة الوجدانية في عالمه الشعري، ونسعد دائمًا بالتعرف على رؤيته وإبداعاته التي تجمع بين التراث والحداثة.
كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى مجلس الحكواتي الثقافي على دعمه المتواصل للمشهد الأدبي والثقافي، وإلى الأستاذ فايل المطاعني على إدارته هذا الحوار الممتع والمثرِي بروح الحكواتي وعذوبة القلم.