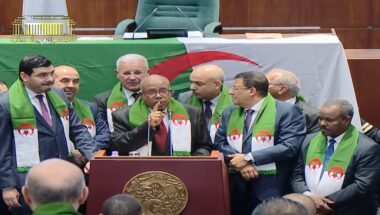حكايات من الواقع
الحكايه الرابعة : غربة مشاعر
د. ريم محمد خميس الحشار
في هدوءٍ وسكون لاحدى الليالي اللطيفه؛ كنت اجلس على الأريكة، والضوء الخافت يضي مساحة المكان ويغمرني بلطفه و بهدوء لونه الذهبي الخافت. وكان بين احضاني ما نسميه في العالم الحديث باللغة الانجليزية ” الابتوب ” والذي احتضنته لكي أوثق فيه بأناملي السلسلة السردية “حكايات من الواقع” مثلما إعتدت . وذلك بعد ما عادت لي مشاعر الابداع الكتابي بعد إنقطاع نتيجة الاشغال؛ لإستكمال السلسلة وسرد الحكاية الرابعة.
وبينما كنت في هذا الجو الشاعري؛ راود خاطري بعضًا من الكلمات التي كتبتها في مرحلة من مراحل التغيير الحقيقية في حياتي الشخصية.
وهي نصًا تقول:
” يسبق كل مرحلة من مراحل التغيير هزه يعقبها سكون قابل لتغير المحيط او الواقع لمستقبلٍ أجمل”
وذكرا للطافة شعور اللحظه في هذه الليلة ودمجًا لعلاقة المشاعر في توجيه الانسان وكونه المحرك الاساسي للتغيير من وجهة نظري؛ فقد كانت “المشاعر” هي المحرك الاساسي للتغير في حياتي الشخصية. فالمشاعر او العواطف تتسيد المواقف التي واجهتها في حياتي كلها. وكان “الفكر اوالعقل” هو ميزان الامور والمستشار لتقويم المسار للاتجاه المناسب.
واحسب ان كل ذلك أسهم في صياغة مفهوم تلقائي في التعاطي مع الحياة وتحدياتها وأسهم في نحت بعضًا من ملامح الذكاء العاطفي في شخصيتي.
و ساقني ذلك للتفكير بما يسمى ب ” الذكاء العاطفي” ليقتحم فكري “احمد” ويعيد شريط الذكريات لأكثر من عشرِ سنوات فاتت ويسرد الحكاية ويتسيد المشهد ويكون بطلا لحكايتنا الرابعة!
فمن هو احمد؟
وكيف أصبح بطلاً للحكاية الرابعة؟
وما علاقته بالمشاعر والذكاء العاطفي ؟
لتبدأ الحكاية:
كان يوما يعج بالمرضى ينهلون من كل حدب وصوب. وكنت يومها قد أوكلت إليّ مهمة إستلام غُرفة الطواري. وكانت غرفة الطواري تتوسط المركز الصحي وبها بابان يربطان الطرف الشرقي للمركز بالغربي. وكانت الحركة فيها متواصلة للطاقم الطبي ومرتادي المركز من المرضى. فتارةً تُشاهد الممرضة وهي تُغلق الستار لتجديد الضماد لأحدهم, وترى الاخرى وهي تفعل ذات الشي لحقن الأنسولين لكبيرة في السن, وترى الثالثة تستقبل الحالات وتوثق على الحاسب الألي وتنتقل الى جهاز الاكسجين لتحضر الدواء لمن يعاني من مشاكل الجهاز التنفسي الحاد والتي تحتاج لجرعات دوائية مباشرة من جهاز الاكسجين لتلقي الدواء مباشرة عبر التنفس.
وفي وسط المعمعة؛ يدخل شاب في بداية العشرينات متوسط الطول و شعر رأسه كثيف ولون بشرته حنطي مصّفر وشاحب!
يرتدي ثوب رجال عماني (لونه كركمي : مائل الى اللون الاصفر قليلا ) يظهر عليه أنه غريب وليس من العاصمة لانه كان يتحدث بلهجة قاطني جنوب عمان.
شد انتباهي هدوئه ووقوفه المريب وقد كان يكح كحة بسيطة!
فبأدرت في سؤاله عن سبب قدومه للمركز؟
قال : أُريد بخار (وهو علاج الاكسجين التنفسي) !
قلت: هل لك زيارة سابقة ؟
قال : لا , انا متعودٌ على اخذ جرعات البخار وارتاح عليها في ازمات ضيق التنفس !
قلت: إسترح ؛ أريد ان افحصك .
قال بهدوء : لا داعي! أعطيني البخار انا متعود سيريحني اعلم ذلك .
قلت: إسمحلي ان افحصك. لأُحدد الحالة وأُعطيك العلاج المناسب.
فقَبِل بذلك وعرفت منه انه مريض للربو ولكنه غير ملتزم بعلاجه كما انه ” مدّخن” !
كانت رئتاه تغرقان فالفحص الذي اجريته عليه, و تبحثان عن ما ينقذهما ولم يكن للهواء سبيل إليهما .
فبدأت معه أولى جرعات الإنقاذ التي كنت أحسب أنها ستكون بالكثير جلسة بخار او اثنتين !
ولكن المفاجئة كانت تكمن في أن حالته لا تتحسن وكنت كلما سألته عن حاله قال : احسن !
لم أكن مطمئنة لوضع رئتاه؛ فقد كانت رئتاه تزداد سوءًا.
ليدق ناقوس الخطر وتظهر اشد العلامات الحمراء التي استنفرت فيها مشاعري وتأهبت فيها قواي العقليه للاستعداد لحالة طوارئ حقيقية.
كانت وقتها رئتهاه لا تحصل على الاكسجين و تتعاون مع عضلات القفص الصدري لتكوين حاله من الكحة المستمره لشفط الهواء في حركة متكررة. وكان من مشاهد الذعر التي أججت لدي حالة الإستنفار؛ هو أنه بدأ يكح والدم يملئ المنديل الذي كان يستعمله كستار يغلق به فمه. والغريب انه لم يُعلمني بذلك ؛ وإنما شاهدته بالمصادفة وانا أطمئن على حالته!
لأُعلن حالة الاستنفار القصوى في المركز الصحي ونتعامل مع حاله “احمد” على أنها حاله قد تكون مصابة بمرض معدي شديد الخطورة. نتيجة للاعراض المصاحبة لحالته.
وتم الاستنفار بإغلاق الابواب لعزل الحاله في غرقة الطواري عن باقي المرضى في محيط المركز. وتم إستدعاء سيارة الاسعاف لنقله للمستشفى المرجعي لتلقي العلاج المكثف والمناسب لأنه وبناءًا على المؤشرات الأولية فقط تم تشخيصه بمتلازمة ضيق التنفس الحادة والتي كان يُصحبها نَزيف!
كان ظَني يَحوم بين عدوى الفيروسات التنفسية الحادة وبين مرض السُّل الرئوي. ولم يتعدى ظني قط لأمر أخر !
تم إستقبال الحالة فالمستشفى المرجعي؛ وللمصادفة البحتة فقد كانت زميلتي وهي طبيبة اخصائية في قسم الاشعة في مناوبة ليلية للاشراف على الحالات والتي تستدعي تصوير اشعاعي طارئ.
اخبرتني ، انه تقرر له صورة للاشعة وانه تم تسجيله كحالة شديدة الخطورة ونُقِل للعناية الفائقة. وتم إكتشاف بعد التصوير الإشعاعي أنَّ الرئة مليئة بالنزيف الداخلي والذي ملأ الرئتين وأغرقها غرقا شبه كامل.
وفي قسم العناية الطبية المشددة كان جسده لا يستجب لأيٍّ من العلاجات التي قدمت له من قبل الطاقم الطبي.
فكان جسده قد فقد السيطرة وأصبح الجهاز المناعي يُهاجم نفسه في حالة اشبه بفقد الوعي والانتحار المتعمد -تشبيه- و فيها يفقد الجسد المُصاب بالمرض والضّعف المناعي السيطرة على نفسه ظنا منه (كناية عن الجسد) أنه يُحاول بذلك السيطرة على الاختلال الحاصل .
كنت فالمقابل قلقة جدًا؛ ولم أنم الليل لقلقي الشديد عليه.
وفي الصباح صحوت بعد غفوه بسيطة عندما إنقطع الإتصال بزميلتي والتي كان أخر ما أبلغتني به هو أن رئتاه في حالة سيئة وأنهما تنزفان.
وقتها كُنت أستعدُ للذهاب للعمل: وبدأتُ صباحي ب حالة شعورية مشتتة وقلقة وفاقدة للتركيز على الحالات التي تُعرض عليّ!
وفجاءة؛ تَردُني رِسالة من زميلتي قبل أن يَنتهي العمل الصباحي بثلاث ساعات.
لتبلغني بما لم يكن في الحسبان!
وتقول : كيف حالك؟
أجبت : الحمدُلله ؛ كيف احمد ؟
قالت: أُبلغتُ بعد مراسلتك بطلب تصوير اشعاعي أخر لاحمد لتحديد التشخيص بشكل أدق.
قلت : وهل اكتشفتم السبب ؟
قالت: كان قدر الله أبلغ؛ فقد تدهورت الحالة وقد توفاه الله في خلال ست ساعات من لحظة دخوله للمشفى!
قلت : ماذا ؟ والصدمة تسحب الشعور من جسدي لوهلة. وأردد؛ ماذا كان التشخيص أخبريني؟ كيف حصل ذلك؟
وإنهرت وأنا أستجوبها باسئله كثير تسأل عن سبب الوفاه السريع ؟!
واسترسلت؛ لماذا لم تجروا الاشعة؟ لماذا لم تسعفوه!
وهي تقول : يا دكتوره ريم قضاء الله وقدره أبلغ؛ كنت أستعد لإستقباله لعمل الاشعة الثانية. ولكنهم أبلغوني بإلغاء الطلب بسبب الوفاة.
لتنتهي حياة احمد في لحظه أو كما شبهتها في أقل من الثانية بسبب تسارع الاحداث.
وتبدأ حكاية إنهياري الشعوري بالبكاء والنحيب من صدمة الواقعة!
كان حزني عليه مخيف. كنت أتسائل ما الذي حدث ! لقد كان يمشي ؛ كان يكلمني ؛ لم يكن به شيء!
كنت أتشكك في علاجي له؟
ماالذي حصل ؟ هل أنا السبب في موته؟ هل تأخرت في علاجه ؟ هل تأخرنا في تحويله للمستشفى المرجعي الذي يبُعد عن المركز بعشر دقائق !! ما الذي حدث بالضبط؟!
لم تكن لأسئلتي إجابة غير أن قدر الله نافذ.
عشت غُربة من المشاعر بين إيماني بالله ونفاذ أمره وبين تَعلُقي الشعوري بأسباب الحياة. غُربة بين عِلمي بالعلاج والطب وبين مشاعري التي لم تشاء تصديق ما حدث.
وتكررت جمله في ذهني حينها؛
“يا ليتني قدمت لحياتي”
لأتخيل أنني أقولها ل احمد.
ليتك يا احمد إلتزمت بعلاجات الربو!
وليتك يا احمد لم تتبع أصحابك الذين غروك بالتدخين!
وليتك يا احمد ضعفت واعترفت بعجزك ومرضك باكرًا ؛ ولم تُصر على رأيك أنك قوّي لنَمدك بالعلاج المناسب !
كنت في حالة شعورية حزينة جدًا ؛ لم أستطع إكمال اليوم والعنل وإستمريت فالبكاء والتساؤلات الواهية التي شلت الفكر والمنطق حتى نهايه اليوم.
لأعيش بعد حادثة احمد مدة ليست بالبسيط في غُربة من المشاعر والتي لم تسمح للعقل بأن يتدخل وقتها لتلطيف حدت الشعور والتعامل مع الموقف بنوع من الذكاء العاطفي! والذي كان يمكن أن يسمح لي بفهم مشاعري وتحليلها وإدارتها بإدراك ووعي.
رحمة الله على احمد؛ ورحمة الله علينا في أن يُثبت قلوبنا على مرضاتِه و يؤيدنا بالفكر والقول والوعي المُتزن.